الوعي البيئي في لبنان: إشكالية العلاقة بين وسائل الإعلام والجمعيات البيئية(*) - CAUS - مركز دراسات الوحدة العربية
مقدمة:
كان الإعلام دائماً بأدواته المتعددة، وأساليبه المتجددة، ومضامينه المؤثرة، ممهداً للكثير من التحولات الكبرى عبر العصور، فتعاظم دوره وتوسعت مهماته، بحيث غدا حاضراً في مفاصل الحياة اليومية للأفراد والجماعات، وللسلطات الرسمية، ولمنظمات المجتمع المدني، وغيرها. وكما الاتصال نشأ الإعلام كحاجة إنسانية تطورت مع الوقت، فانتقلت من عمل فردي إلى مؤسسة متخصصة، فالإعلام هو في أساس التفاعل البشري القائم على العلاقة الإنسانية. و«منذ وجود هذا التفاعل البشري، يعيش المجتمع الإنساني في إطار ثلاث منظومات رئيسية: المحيط الحيوي، المحيط المصنوع والمحيط الاجتماعي. تنشأ المشكلات البيئية نتيجة خلل أو تدهور في بعض التفاعلات في ما بين المنظومات الثلاث. رغم أن الإنسان ليس مركزاً لمثلث التفاعلات بين المنظومات، إلا أنه يمثل جزءاً من عناصر كل منها. تتفاعل هذه المنظومات إذاً بفعل الإنسان وعمله، ونتيجة هذا التفاعل تؤثر على حياته»[1] في مختلف جوانبها، منها الاجتماعية، والصحية… والبيئية.
وفي لبنان تتفاقم المشكلات البيئية وتتوالى فصولها براً وبحراً وجواً من دون توافر حلول جذرية لها، أبرزها مكبّات النفايات العشوائية، والصرف الصحي، وتلوُّث البحر والشاطئ، وتلوّث نهر الليطاني. واقع بيئي متدهور حذّرت من تداعياته مراراً التقارير العالمية والإنذارات الدولية، وبحسب منظمة الصحة العالمية احتل لبنان في عام 2018 المرتبة الأولى[2] بين دول غرب آسيا في عدد الإصابات بمرض السرطان قياساً على عدد السكان، إذ يوجد 242 مصاباً بالسرطان بين كل 100 ألف لبناني، بينما سجلت أكثر من 17 ألف إصابة جديدة عام 2018، 8976 حالة وفاة في العام نفسه.
وبحسب تقرير منظمة غرينبيس وتحليل البيانات الصادرة عن الأقمار الصناعية في الحقبة الممتدة من 1 حزيران/يونيو إلى 31 آب/أغسطس من عام 2018، احتلت منطقة جونية المرتبة الخامسة عربياً، والـ23 عالمياً من حيث نسبة الغاز الملوِّث ثاني أوكسيد النيتروجين في الهواء.
حيال الإنذارات الدولية وإحصاءات المنظمات البيئية الصادمة، يتبين أن الوعي البيئي المجتمعي لا يوجد بذاته ولذاته إنما هو عمل بنائي تراكمي تتضافر جهود مجموعة أطراف فاعلة في المجتمع ومهتمة بموضوع البيئة على تكوين هذا الوعي. وإذا كانت الجمعيات الناشطة في الحقل البيئي هي المعنية في تكوين هذا الوعي، فإنها تبدو غير قادرة لوحدها على ذلك ويلزمها وسائل وأساليب ومهارات غير متوافرة لديها. من هنا فإن محددات علاقتها بوسائل الإعلام يعدّ عامـلاً مهماً في إشاعة الوعي البيئي في المجتمع. مع الإشارة إلى أن هذه العلاقة بين الطرفين لها امتداداتها بعلاقات أخرى، يجد كل منهما نفسه مضطراً إليها، من ناحية أولى علاقة الجمعيات بالباحثين والدارسين ليتزودوا بالمعطيات الموثقة والدقيقة، ومن ناحية ثانية، علاقة وسائل الإعلام بصناع القرار على المستويين السياسي والاقتصادي.
وعلى الرغم من تضخم المجال الإعلامي، وتنوع وسائله، وعلى الرغم من تكاثر أعداد الجمعيات البيئية في لبنان، وتزايد الناشطين البيئيين، تبرز مشكلة مراوحة الأزمات البيئية من دون إيجاد أي حلول جذرية لها. يضعنا هذا الواقع أمام الإشكالية التالية: هل لنوعية العلاقة بين الجمعيات البيئية ووسائل الإعلام من أثر في مستوى الوعي البيئي والتصدي للأزمات البيئية؟
من خلال هذه الدراسة توسعنا في الإضاءة على العلاقة بين الجمعيات البيئية ووسائل الإعلام في لبنان، لكشف ما إذا كانت هذه العلاقة سوية بين الطرفين أو يشوبها تحديات تُعيق مجالات التعاون بينهما. كذلك أظهرت الدراسة الظروف التي تحكم آلية عمل عيّنة من الجمعيات البيئية وعيِّنة من الصحافيين البيئيين في ضوء تجاربهم في معالجة الملف البيئي في مؤسساتهم الإعلامية، لنتمكن من تحديد نوعية العلاقة بين الطرفين وأثرها في تعزيز الوعي البيئي المجتمعي وبالتالي الحد من الأزمات البيئية.
أولاً: قلق سبق الإعلام البيئي
في مراجعة للمسار التاريخي الذي شهده الاهتمام البيئي، وقبل أن تتكوّن هوية الإعلام البيئي، برز قلق الإنسان على بيئته منذ عصر الحياة الزراعية التي تميَّزت بأعراف وتقاليد هدفت إلى تنظيم عملية جني المحاصيل، والتحطيب، ونوعية المواشي التي تذبح وغيرها من العادات التي تشير إلى اهتمام الإنسان المبكر بحماية البيئة ومواردها. إلا أن الاهتمام البيئي لم يستمر خلال العصور المتعاقبة، وتحديداً في عصر الثورة الصناعية، حيث أدى التطور التقني الآلي والعلمي والتقاني إلى جموح الإنسان في استخراج الموارد الطبيعية واستنزافها، وفي مضاعفة المحاصيل الزراعية، على النحو الذي يضر بالبيئة ويخل بتوازن النظام الطبيعي والإيكولوجي، وهو ما أيقظ الوعي لدى بعض العلماء والباحثين تجاه مخاطر الآثار السلبية التي تتركها تلك الثورة وتبعاتها في البيئة؛ فظهرت في بدايات النصف الثاني من القرن الماضي مجموعة من الدراسات المحذّرة من هذا التعاطي، منها كتاب الربيع الصامت لعالمة الأحياء راشيل كارسون (Carson Rachelle) الصادر في عام 1962، والذي مثّل جرس إنذار لتدارك آثار الحضارة الصناعية في البيئة في الولايات المتحدة. وقد لفتت كارسون الأنظار في كتابها إلى قضية اختفاء أنواع من الطيور، وما لحق الحياة البرية من أذى نتيجة الاستخدام المتزايد للمبيدات والمواد الكيميائية الزراعية. نتيجة الجدل الذي أثير بعد هذا الكتاب على المستوى القومي، أصبح هناك تيار شعبي ضاغط مهتم بحماية البيئة، وهذا ما دفع الكونغرس إلى إصدار قانون السياسة الوطني للبيئة عام 1969.
ولكن لم يبرز الاهتمام الجدي بالقضايا البيئية، ولم تبدأ ملامح الإعلام البيئي تتكوّن إلا مع اهتمام الحكومات وعقد مؤتمر ستوكهولم، تحت شعار «نحن لا نملك إلا كرة أرضية واحدة» في عام 1972، وفيه تم إطلاق أوّل تعريف رسمي للبيئة، بأنها: «جملة الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته». واعترف المجتمعون بدور التربية البيئية بوصفها من مداميك المحافظة على البيئة ونشر الوعي البيئي. إلا أن اهتمام معظم الحكومات بالقضايا البيئية بدأ بطيئاً وخصوصاً مع تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الوثيقة المتعلة بحقوق الدول وواجباتها، التي أكّدت «حقوق الدول في التنمية من دون الإشارة للمعايير البيئية»، فتجاهلت الدول المتقدمة قضية البيئة وتنصّلت من مسؤولياتها حيال التداعيات البيئية المترتبة على أنشطتها الاقتصادية. فاستمر الكباش بين البيئيين والصناعيين، إلى أن «برزت النقطة الحاسمة في عام 1983، بعدما طلب الأمين العام للأمم المتحدة من رئيسة وزراء النرويج غرو هارلم برونتلاند (Gro Harlem Brundtland)[3] تأليف لجنة للبحث عن أفضل السبل التي تمكّن كوكب الأرض، الذي يشهد نمواً متسارعاً، من أن يستمر في إيفاء الحاجات الأساسية من خلال صياغة افتراضات علمية تربط قضايا التنمية بالعناية بالبيئة والمحافظة عليها. وبالتزامن مع نشر الوكالة العالمية للبيئة والتنمية لتقريرها «مستقبلنا المشترك» في عام 1987، جاءت الصدمة البيئية الكبرى للرأي العام، ألا وهي اكتشاف ثقب الأوزون في القارة المتجمدة الجنوبية، التي دفعت إلى الاتفاق في العام نفسه على بروتوكول مونتريال لمعاهدة فيينا، حول حماية طبقة الأوزون، وأصبح مفهوم «التنمية المستدامة»[4]، مفهوماً محورياً للتفكير المستقبلي».
مع تزايد الاهتمام البيئي تدريجاً اتسعت نظرة الرأي العام إلى القضايا البيئية، وتحديداً مع عقد منطقة ريو دوجينيرو أوّل قمة بيئية عالمية، بعنوان: «قمة الأرض»، في عام 1992. تكمن أهمية هذه القمة في أنها جذبت أنظار الرأي العام إلى البيئة، ومهدت الطريق أمام مفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بالتغيرات المناخية. في هذه القمة، ألزم المجتمع الدولي نفسه بمفهوم التنمية المستدامة، وصاغ قانوناً دولياً بيئياً، إضافة إلى تبنيه اتفاقيتين عن تغير المناخ، وعن التنوع البيئي. هذه القمة نقلت الحديث عن القضية البيئية إلى مرحلة «تدويل الإشكالية البيئية، (L’Internationalisation de la problématique environnementale)[5]. في هذه المرحلة تنامى الوعي البيئي وظهرت حركات بيئية قادها مفكرون ومثقفون في الغرب. وبدأت تتثبت معالم الإعلام البيئي وتتسع أدواره ليس عبر إيصال رسائل الحركات البيئية إلى الجماهير فقط، إنما عبر إشراكهم وحثّهم على تبديل سلوكياتهم المضرة بالبيئة.
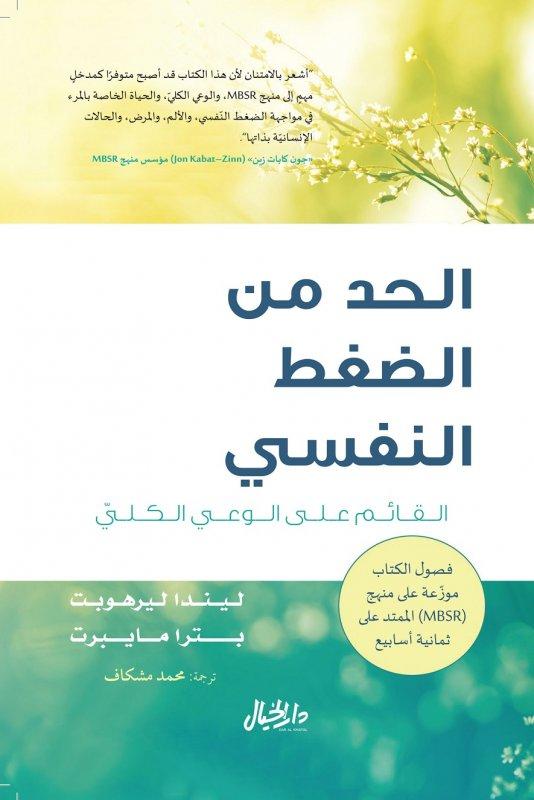
ثانياً: واقع الجمعيات البيئية في لبنان
يصعب تعداد الجمعيات البيئية غير الحكومية المنتشرة في العالم، أما في لبنان «فيتجاوز عددها الـ 816 جمعية بيئية مسجلة»، بحسب رئيسة مصلحة التوجيه البيئي في وزارة البيئة المهندسة لينا يموت[6]. تتوقف يموت عند التقرير الإحصائي الذي أجرته وزارة البيئة عن أعداد الجمعيات البيئية بين أعوام 2008 و2016، فتوضح: «قسمنا الجمعيات المسجلة إلى فئات: الأولى فئة (أ) تضم الجمعيات التي أهدافها التأسيسية 100 بالمئة بيئية، الثانية فئة (ب) تضم الجمعيات البيئية التي أهدافها التأسيسية 50 بالمئة و75 بالمئة بيئية، الفئة الثالثة (ج) تضم الجمعيات التي أهدافها التأسيسية أقل من 50 بالمئة بيئية» وقد تبين لنا أن الجمعيات الفئة (أ) التي هي بيئية صرف عددها 65 فقط، وجمعيات الفئة (ب) عددها 51، أما الأغلبية فكانت للجمعيات من الفئة (ج) التي أهدافها البيئية لا تتجاوز 50 بالمئة، وعددها 700.
تتعدد التسميات التي تندرج تحتها الجمعيات، ويطغى عليها في الإجمال العمومية والرمزية، إذ لا ينطبق عليها مقولة «يُقرأ المكتوب من عنوانه»، نظراً إلى أن قلة قليلة من الجمعيات يمكن الاستدلال إلى أهدافها ودورها من تسميتها. هذا المؤشر لا يمكن الاستخفاف به، فهو يحمل في طياته دلالة على غياب التخصصية إلى حد كبير في صفوف بعض الجمعيات وإظهار نفسها على أنها ملمّة بالقضايا البيئية كافة. في هذا السياق تأسف يموت لغياب التخصصية، قائلة إن الإلمام بمختلف الشؤون البيئية مسألة مهمة، «إلا أن جمعياتنا تفتقر إلى التخصص والتعمق بتفاصيل بيئية، ولا سيَّما أن مع تداخل القضايا البيئية والتطور التكنولوجي السريع، بِتنا في منافسة من نوع آخر، لم يعد بوسع أي شخص الإلمام بأي موضوع، ولا بد من الاتجاه نحو التخصصية. المؤسف أننا بتنا نرى المحامي يتحدث في البيئة، وأستاذ التاريخ يحاضر بالبيئة، وكل من أحب الظهور إعلامياً يتوسل البيئة، في المقابل أحياناً لا نجد شخصاً أو شخصين متخصصين في جمعية بيئية، حائزين شهادات في مجالات البيئة».
ويعود جزء من إصرار معظم الجمعيات البيئية على إلمامها بمختلف القضايا البيئية، إلى رغبة مبطنة لديها في استمالة الجهة الممولة، فهي بابتعادها من التخصص تبقي على هامش أوسع يمكنها من تبني المشاريع واجتذاب الممولين. وهذا ما يؤدي إلى رفع مستوى المنافسة بين الجمعيات من دون ضمان إيصال الرسالة البيئية الصائبة. في هذا الصدد توضح يموت: «بعض الجمعيات أخذت على عاتقها مكافحة الحرائق أو حماية الغابات، فبدت ممسكة بملفاتها، أما من تشعبت أهدافها فنجدها تتخبط، وتراوح مكانها وأحياناً كثيرة تضيّع هدفها الأساس، والدليل أن الجمعيات التي تنجح في استقطاب تمويل خارجي لتنفيذ مشاريع محلية، لا يتجاوز عددها أصابع اليدين».
وحيال عشوائية استضافة وسائل الإعلام لشخصيات تحت صفة «خبير بيئي»، تلفت يموت إلى كتاب رسمي تحذيري وجهته وزارة البيئة لوسائل الإعلام كافة منذ أيلول/سبتمبر عام 2015، مفاده «أن البيئة هي علم شاسع بحد ذاته، ولا يمكن لوسائل الإعلام محاورة مواطنين ينتمون إلى هيئات بيئية وتطلب منهم معلومات علمية حول مواضيع ومشكلات بيئية، مطلقة عليهم تسمية خبراء بيئة، لذا عليها التأكّد قبل استضافة هؤلاء من الشهادات التي يحملونها».
تتفاوت وتيرة أنشطة الجمعيات البيئية في لبنان، بعضها تتسم حركته بالموسمية وبعضها الآخر لا يتحرك إلا بعد وقوع مشكلة أو تأزم قضية، والمثل الأقرب إلى ذهننا، قضية التخلص من النفايات والجدل الذي رافق إقفال مطمر الناعمة، إذ تعلو صرخة الجمعيات البيئية بين الفينة والأخرى، لتعود ويخفت صوتها ثم تعاود التصعيد. وكمثال آخر على موسمية حركة الجمعيات البيئية، تلك التي تعنى بحماية الشاطئ، إذ تكاد تطل مرة في السنة، وسرعان ما تتلاشى همتها وتغيب معها حملات التوعية على مدار السنة، إضافة إلى قضية تلوث نهر الليطاني التي تراوح مكانها.
إن تشعّب مهمات العدد الأكبر من الجمعيات البيئية، يمنعها من التركيز على تنفيذ أهدافها وتحقيق كامل برامجها. كما أن اعتماد الجمعيات الكلي بالدرجة الأولى على متطوعين لهم انشغالاتهم الخاصة في الحياة اليومية، يبطئ حركتها. على سبيل المثال تدعو غالباً إحدى الجمعيات إلى حملة تشجير، وسرعان ما يحصد الإعلان عن النشاط مئات الـ likes، والتعليقات المرحبة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعندما يحين يوم تنفيذ النشاط البيئي يتدنى عدد المشاركين، وأحياناً يتم تأجيل النشاط إلى حين تأمين ناشطين أو طلاب مدارس أو الاستعانة بجمعيات أخرى. أضف إلى ذلك مشكلة التمويل التي تشكوها معظم الجمعيات على حد سواء. في المقابل تبدي جمعيات مستوى عالياً من المسؤولية والالتزام ولا سيَّما تلك التي تنشط في لجان تشرف عليها وزارة البيئة، والتي انخرطت في مجالس مثل المجلس الوطني للصيد البري، والمجلس الوطني للمقالع والكسارات، والمجلس الوطني للبيئة.
ثالثاً: إشكالية العلاقة بين الجمعيات البيئية ووسائل الإعلام
في ورقة بحثية بعنوان: «دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في الإدارة البيئية العالمية»[7]، تلفت بربرا غميل[8] وأبيمبولا باميدلي – إيزو[9] إلى خمسة أدوار رئيسية تؤديها منظمات المجتمع المدني وهي: «جمع المعلومات ونشرها، تطوير السياسات الاستشارية، تنفيذ سياسات، التقييم والرصد، الدعوة إلى إحلال العدالة». انطلاقاً من هذه الأدوار المنوطة بها، تبرز مسؤولية هيئات المجتمع المدني عامة، والجمعيات البيئية خاصة في مساعدة الإعلام لكي يرتقي إلى مستوى تحفيز المواطن على تغيير سلوكه وأساليب تعامله مع البيئة. لذا بقدر ازدهار أنشطة الجمعيات البيئية، وتماسك معطياتها، وقوة رصدها وغنى بياناتها، تتوسع أدوارها وتتعمق مسؤوليتها في مساندة الإعلام البيئي على القيام بدوره. فالجمعيات المواكبة للوضع البيئي ومستجداته لحظة بلحظة، ستُغني الإعلام بما تملك من معطيات، بينما الجمعيات ذات الداتا الهزيلة، ستعجز عن تزويد الصحافيين بالأرقام الدقيقة والمعطيات الحديثة التي قد يحتاجون إليها في إعدادهم موادهم الصحافية. من هنا يتبين أنه في جزء من ضعف مهارات الصحافيين محدودية مهارات الجمعيات والناشطين البيئيين. وهذا ما دفعنا إلى البحث عن طبيعة العلاقة بين الجمعيات البيئية في لبنان ووسائل الإعلام، وفيما إذا كانت الجمعيات البيئية تخصص دورات وورش عمل للصحافيين، وفي الوقت عينه فيما إذا كانت تُدرّب عناصرها على اكتساب مهارات إعلامية، كذلك معرفة مدى حاجة كل من الطرفين إلى الآخر.
وبغرض معرفة مدى مساندة الجمعيات البيئية للإعلام اللبناني ومساعدته على إشاعة وعي بيئي، وبالتالي الحد من الأزمات. أجرينا مقابلة نصف موجهة، مع عشر جمعيات بيئية[10]، تضمنت 72 سؤالاً، موزعة ضمن محورين: الأول يركّز على المهارات التواصلية لدى كل جمعية إضافة إلى هويتها، عملها، أهدافها… أما المحور الثاني فيذهب أبعد من الأمور الداخلية، إلى اهتمامها بالعملية الإعلامية وطروحاتها حول إمكان الإعلام إشاعة ثقافة بيئية في أساليب عمله. (هل تتواصل الجمعية مع وسائل الإعلام؟ لماذا؟ ما الغاية من التواصل؟ هل سبق أن طلبت وسيلة إعلامية منها تزويدها بوثائق وأرقام؟ متى تلجأ الجمعية إلى الإعلام؟).
لذا سنحاول في ما يلي الوقوف عند العلاقة من منظور الطرفين: الجمعيات البيئية من ناحية والصحافيين البيئيين من ناحية ثانية.
1 – العلاقة بين الجمعيات البيئية والإعلاممن منظور الجمعيات نفسها
أ – الجمعيات البيئية والمهارات التواصلية
في معرض بحثنا عن وعي الجمعيات لأهمية الاتصال، يتبيّن أن الأغلبية، بمعدل سبع جمعيات من أصل عشر جمعيات، رأت أنها تولي الاهتمام الكافي للاتصال. في حين ذكرت جمعيتان أنّ مهاراتها قوية إلى حد ما، وجمعية واحدة صنفت مهاراتها التواصلية بالضعيفة. ولدى البحث في الأساليب المعتمدة، نجد أن جمعية واحدة من أصل عشر جمعيات لديها ملحق إعلامي، وهي «الاتحاد اللبناني لحماية البيئة»، الذي يضم تحت لوائه نحو خمس وأربعين جمعية بيئية من مختلف المناطق اللبنانية. في حين تجد الجمعيات التسع أنه يتعذر على الجمعيات متواضعة الحجم اعتماد ملحق إعلامي لأسباب مادية. كذلك يتبين أن خمس جمعيات بمعدل النصف تملك موقعاً إلكترونياً، بينما اكتفى النصف الآخر بالاعتماد على تفعيل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي جولة سريعة على المواقع الإلكترونية الخاصة بتلك الجمعيات، بدا مستغرباً غياب التحديث المستمر عنها، بعضها توقف الزمن عنده العام المنصرم أو عند آخر نشاط بيئي نفذته الجمعية. فقد بدا واضحاً غياب من يشرف على الموقع ويجدد مضامينه، ناهيك بأن بعض المواقع يفتقر إلى خريطة، يتعذر على المتصفح التجوال فيه وأخذ المعلومة المناسبة. في المقابل راقبنا حركة الجمعيات البيئية التي تعتمد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فوجدناها دائمة الحركة والتفعيل، تبعث غالباً برسالة بيئية لمتتبعيها، ولا تقف على حدود نشر صور عن أنشطة قديمة للجمعية، بل تتفاعل مع المشكلات البيئية اليومية والقضايا المحيطة، وتفسح في المجال أمام متتبعبها لتبادل الآراء.
على مستوى إصدار الجمعيات لنشرات بيئية خاصة بها، تبين أن ثماني جمعيات من أصل عشر لا تصدر أي نشرة، عازية الأسباب إلى عدم توافر الوقت لإعداد ذلك، وعدم توافر الأموال، وقلة عدد الأعضاء، إلى جانب أنها تجد أن الناس لا يحبون القراءة. في حين تحرص جمعيتان فقط على إصدار نشرة. وفي نظرة سريعة على إحدى هاتين النشرتين، نلاحظ أنها عبارة عن مجلة غنية بالصور والأخبار غير البيئية، كالولائم والتكريمات ولقاءات خاصة برئيس/ة الجمعية. وأشارت جمعية واحدة من أصل عشر إلى امتلاكها مرصداً بيئياً، الغاية منه «رصد مختلف أنواع المخالفات البيئية من ردميات، وتعدّيات، وقطع الأشجار، وصيد عشوائي، ورمي النفايات، وحرائق الغابات». بينما رأت تسع جمعيات أنها تفتقر إلى أمور أكثر أساسية والتصاقاً بآلية عملها، من تمويل إلى ملحق إعلامي، فمكتب مجهز بتقنيات حديثة…
وتفاوتت آراء الجمعيات حول امتلاكها أرشيفاً بيئياً خاصاً بها؛ أربع جمعيات أكّدت أنها تحتفظ في مكاتبها بأرشيف بيئي يمكن من يشاء الاطلاع عليه، في حين تملك جمعية واحدة أرشيفاً إلا أن الإستعانة به حكر على المنتسبين إليها. أما الجمعيات المتبقية، فتعتمد على أرشفة فردية، أي أن كل فرد يحتفظ بما يخصه، معتبرة أن لا حاجة للأرشفة في ظل وجود الإنترنت «فيمكن استرجاع المعلومات بكبسة زر». ومن الأمور الأساسية التي تعذّر على الجمعيات حسمها، هي أعداد المنتسبين إليها؛ فغالباً ما يتم تعداد الرئيس، وأمين السرّ وأمين الصندوق، ثمّ تبدأ التقديرات، وخصوصاً أن معظم المنتسبين متطوعون غير محكومين بدوام إنما تتم المراهنة على روح الالتزام لديهم. في هذا المجال لكل جمعية خصوصية، فبعضها يشكو تدني حضور الأعضاء في الاجتماعات الشهرية، إلا أنهم يشاركون في الأنشطة الميدانية وحملات التوعية. وتعجز جمعيات أخرى عن تنفيذ كامل برامجها لتعذر تأمين الناشطين. في هذا السياق، تؤكّد رئيسة جمعية «سيدس. انت» باتريسيا صفير: «يشارك غالباً نصف عدد الذين أكّدوا مشاركتهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما يفرض علينا تعديلات على النشاط»، ناهيك بغيرها من المشكلات، بما فيها تقديم الأعذار في اللحظة الأخيرة، وإعطاء الأولوية لارتباطات عائلية على حساب الأنشطة البيئية.
على مستوى تدريب الجمعيات للمنتسبين إليها على اكتساب ثقافة بيئية، تبين أن تسع جمعيات من أصل عشر تحرص على تدريب أعضائها على اكتساب مهارات بيئية، بوتيرة غير منتظمة، تراوح بين مرتين في السنة إلى عشر مرات. وتكون غالباً موضوعات الدورات وأهدافها مرتبطة بالمشروع الذي تنفذه الجمعية، فيتم تدريب المنتسبين على نحو يدركون معه التعامل مع الإشكالية المطروحة. وأبرز الموضوعات التي تناولتها الجمعيات: إدارة الغابات، مكافحة الحرائق، المحميات الطبيعية، تلوث المياه، الحفاظ على التنوع البيولوجي، زراعة النباتات، فرز النفايات… وغيرها. أما بالنسبة إلى المحاضرين، فيتنوعون بين جهة أجنبية، دولية، سفارات، متطوعين، أكاديميين، بيئيين من جمعيات زميلة.
أما في شأن تدريب الجمعيات لأعضائها على اكتساب مهارات في الإعلام، وجدنا أن جمعية واحدة من أصل عشر تدرّب أعضاءها على اكتساب مهارات في الإعلام، إذ يتم إرسال مجموعة من الأعضاء مرتين في السنة لل في دورات في الخارج. أما الموضوعات التي يتم التدريب عليها فهي: كتابة خبر، ترويج فكرة، فن العناوين، فن الخطاب، وغيرها من الأدوات التي يحتاج إليها البيئي في تواصله مع الآخرين. في هذا السياق، يقول زاهر رضوان، رئيس جمعية «اليد الخضراء»، في ضوء تجربته تدريب الأعضاء لاكتساب مهارات في الإعلام: «إن مردود التدريب لم يكن بحجم الاستثمار فيه، نرسل الشباب لل في دورات في الخارج، وبعد مدة من عودتهم عوضاً من أن ينقلوا مهاراتهم إلى زملائهم، قد يتركون الجمعية، وبالتالي تكون الجمعية قد كابدت عبء التكاليف». ولكنه يؤكّد أن الجمعيات لم يعد بوسعها تجاهل لغة الإعلام، لأنها ستبقى وحيدة تغرّد في سربها. ولكي تصل إلى أوسع شريحة من الجمهور، لا بد من أن تتقن اللغة الأوسع وهي الإعلام.










