هل يرتدّ كيدهم إلى نحرهم؟
} فيوليت داغر
لقد عشنا خلال السنتين الماضيتين مع ما يُعرف بـ «جائحة كورونا» الكثير من التهويل والإجراءات القسرية التي تمّ التمادي بها في العديد من دول العالم. لكن، هناك منها من بدأ مؤخراً بالتراجع عنها، في حين استمرّ قسم آخر بالضرب بعرض الحائط بكلّ الأدلة التي أظهرت الضلال الذي اعتمد في التعاطي مع هذا المستجدّ. فرنسا واحدة من هذه الدول، رغم أنّ تقارير جديدة أظهرت أنّ نسبة الإصابات بالكوفيد باتت أكبر بين أعداد الملقحين، وأنّ 2% فقط ممن دخلوا المستشفيات للعلاج خلال 2020 كان بسبب الكوفيد، ومن احتاج منهم للإنعاش بلغ 5%. مع ذلك اتخذت إجراءات قمعية عديدة، حتى كاد يخيّل للناس أنّ الموت بالانتظار على الأبواب لكلّ من يطلّ برأسه خارجها.
هذا الهذيان الذي اتخذ مسمّى الحماية الصحية كان له أن يبلغ أبعاداً غير متخيّلة. رافقته حالات رعب وإحباط وكآبة، أحدثت تأثيرات جمّة على الصحة العقلية والنفسية والجسدية للمواطنين. وهذا ليس بمستغرب إنْ علمنا أنّ الكثير من الدراسات تؤشر إلى أنّ 75% على الأقلّ من مشاكلنا الصحية عموماً تسبّبها مشاعر من نوع القلق والكره والغضب والخوف. هذه المشاعر تخفض إنتاج الخلايا المناعية وتستجرّ أمراضاً عديدة من القلب إلى السرطان وهلم جرا، انطلاقاً من عمل الجهاز العصبي المركزي وتأثيره على الدماغ وتراجع إنتاج الخلايا داخله.
من المعلوم أنّ البشر مطبوعون على الحياة الجماعية، وأنّ الفرد يذوب في المجموعة. بالتالي، حرية حركته وتفكيره تبقى في لاوعيه مقيّدة، كونه يخشى عزله من الجماعة. لزمن سابق كان الخروج من الجماعة بمثابة حكم بالموت. ورغم التطور التكنولوجي، ما زال الدماغ البشري يتحرك بموجب تلك القوانين، همّه إرضاء المجموعة حتى ولو في العلن جاهر بشيء هو عكسه في سرّه. والسلطة التي تعلم هذه الحقيقة تستعملها لتطويع الناس بموجبها. هي تلجأ للتأثير على المشاعر وتحريك المخاوف، بهدف تعويد المجموعة على قبول المعطيات دون تفكير لتصبح طيّعة. فالمستبدّ لم يمسك بناصية المجتمع لو لم يستقل الأفراد من مسؤولياتهم ويقايضوا بحرية رأي وتفكير كانت لديهم.. في المقابل، السباحة بعكس التيار مجلبة للمشاكل، فلماذا التفرّد؟ أما من يستطيع فعل ذلك يتحلى بشجاعة وصلابة يُحسد عليها وإنْ حورب من أجلها.
خلال السنتين الماضيتين كانت الازدواجية بين المنطوق به عن الحريات والرغبة بفرض حكم توتاليتاري وإرهاب فكري لا مثيل لها. الجميع يعزف على نفس الأوتار، بتوجيه من قلة تتحكم بالعالم، من شركات أدوية وذكاء اصطناعي وإعلام مروج لإيديولوجية مدروسة ومحكمة التطبيق لا يمكن مخالفتها. لقد فرضت طريقة في الوقاية من المرض، بينما هي التي تنشر المرض وتسعى ليكون أداة لجني المزيد من الأرباح عبر لقاحات ليس من معلومات كافية حولها بحجة أنها في مرحلة تجريبية.
فالتوتاليتارية تخشى المساءلة، كونها تشكل خطراً على سلطتها ومنطقها ووجودها. هي تهدّد مساعيها للإمساك بناصية المجتمعات. لذا رأينا كيف كان التعاون وثيقاً بين أطراف الأحلاف المجتمعة لإحلال المخطط المبيّت. لقد اتفقوا في ما بينهم على فرض 4 لقاحات لا غير، وما عداها لا إقرار أو توافق حوله، كما لا نصائح أو توصيات بكيفية تقوية المناعة. – وهنا كلمة لقاح هي تجنّي على الحقيقة، كون الأنسب هو تسمية «تقنية التعديل الجيني». ثم منذ متى كان يغلق ويحظر على من ليسوا مرضى، ولم يقترفوا جرماً أو جنحة، اللهم إلا رفضهم أن يكونوا في أعداد حيوانات التجارب؟ مع ذلك استمر التمييز اللاعقلاني والعنفي بين البشر، خلافاً لكلّ منطق أو علم. ورغم التيقن مع مرور الوقت أنّ التلقيح لا يحمي أو يمنع من انتقال المرض، استمرّ عنف الإجراءات بشكل تصاعدي. ورغم التبليغ عن الأخطار وظهور الحقائق المريبة والأرقام التي تكذب الأقوال، استمرّت شريحة واسعة من البشر بالخضوع للأوامر القاتلة وكأنه لا حياة لمن تنادي.
لقد عاشت البشرية حقبات تاريخية مرت خلالها بأنظمة توتاليتارية عديدة، لكن لم يكن الوضع معمّماً ومعولماً كما نشهده اليوم عبر نشر الفيروس وملحقاته. إلى جانب أنّ الديكتاتور هذه المرة ليس له وجه محدّد لإدانته أو تحميله المسؤولية. لتصبح بذلك الآلية أن يأخذ الفرد على عاتقه معاقبة نفسه ومن حوله عبر التدمير الذاتي.
من منا لم يلمس كيف جري نفي الحقيقة وخلق هذيان لا ينطبق على الواقع ولا يقبل أيّ اعتراض، ليتحوّل إلى جنون جمعي أصبح معدياً كالفيروس. هذا الهذيان حدّد العدو ووجه أكثرية متقبّلة للأطروحات السلطوية ضدّ أقلية معترضة عليه، وإنْ قاومت بأساليب سلمية. مع هذه الهستيريا الجمعية غابت العقول، وأصبح العدو كلّ من لم ينضو ويتقبل الأيديولوجية السائدة.
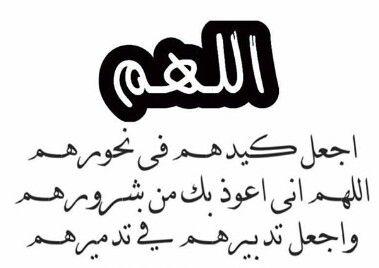
مع التسليم بأنّ الناس كائنات متشابهة، لكنها في الوقت عينه مختلفة ومتفرّدة، وجدنا في الأيديولوجية التوتاليتارية أنّ الجميع يعامل بنفس الطريقة دون تفرقة، وعلى الجميع تقبّل القيود دون مساءلة. والقبول بها، قد لا يكون دوماً نابعاً من رغبة أو قناعة، وإنما أحياناً كثيرة عن خوف وعدم رغبة في المقاومة والتفرّد. خاصة عندما تصدر التوجيهات عن مؤسّسات دولية، كمنظمة الصحة العالمية التي باتت مرجعية الجميع، أو عن شركات لم يتمّ التحرّي عن مصداقية تقاريرها أو مشروعية إنتاجاتها، والتي كثيراً ما بالغت في خططها على اعتماد تكرار الصدمة لنزع الرغبة بالمقاومة.
أليس الجنون قول شيء وفعل شيء معاكس له؟ مما يضيّع العقل ويشتت القدرة على المحاكمة واستعمال المنطق. كان الاعتماد على المغالاة في الكذب، والهذيان، وتغيير الوقائع، والتأثير بالتخويف، للإقناع بأنّ ما يجري ليس سوى للمصلحة العامة. أما ردّ الفعل على التشكيك الممكن والمبرّر، فيتمظهر بالاعتداء متعدّد الأشكال على من يتفرّد. وكأنه هو من يتلاعب بمصائر البشر ويعرّضهم للخطر. وكون المرض هو ما يخيف، وخلف هذا الخوف يقبع الرعب من الموت، قد يبلغ الأمر حدّ الخروج من الحياة بالهروب من المجتمع والانكفاء على الذات بشكل تراجيدي. أو حتى وضع حدّ للحياة في أقصى الحالات.
البعض الآخر فضّل إطاعة الأوامر القاتلة، وهم الأغلبية، كون البقاء في الصفّ ومع المجموعة أسهل تحمّلاً، خاصة مع أخذ العلم بما تتعرّض له الأقلية الرافضة. لكن التوتاليتارية ديدنها الإرهاب الفكري والاعتباطية وليس تقديم ما يطمئن. والرؤوس التي تخرج عن الصفّ تقطف، كونه ليس لها الحقّ حتى بمجرّد البحث عن أجوبة لأسئلة حائرة. وما علينا هنا لنقرب الصورة سوى استذكار كيفية استعمال نماذج المجموعات الإرهابية لآليات التطويع وغسل الأدمغة ليصبح عناصرها أداة طيّعة للقائد الأعلى ينفذ من خلالهم ما خطط له.
فالبرانويا التي هي في قلب التوتاليتارية، تعبّر عن نفسها ليس فقط باضطهاد الآخر، وإنما أيضاً بتحميله المسؤولية عما يحصل له. والأوامر القاتلة لا بدّ من التعايش معها أو السكوت عنها بأسوأ الأحوال. وحيث من الصعب الإقرار بأنّ الذات غير منسجمة مع نفسها، فالأفضل مواصلة نكران الحقيقة التي بدأت تظهر لأنّ فيها تهديد للذات. فالنفس الضعيفة هي دوماً حاضرة للسير في الموكب مهما كان اتجاه البوصلة.
والأخطر هنا، هم من يملكون جانباً من المعرفة بفعل تخصّصاتهم أو وظائفهم. فيتمسّكون بها بحيث تعميهم عن رؤية ما عداها من جوانب أخرى للصورة. وعندما تكون المنطلقات خاطئة تختلط على الشخص، بحيث لا يمكن إصلاحها لتكتمل الصورة.
أما السلطة فهي للأسف تعطي مشروعية لمن يتولى مهام السلطة، ليصبح قوله أو فعله هو الحقيقة المطلقة التي لا ردّ فيها أو جدل. وهذه السلطة هي من أوصلت المجتمع لهذا الانشطار العمودي وما يجرّه من عنف خطير على ذاته. خاصة تجاه من تفرّد وتجرّأ على فعل مقاوم ووجهة نظر نقدية وانفصال عن أغلبية والتضحية بمكانة اجتماعية او مكافآت مالية. تفرّده بموقفه ومواجهته للعمى المجتمعي هو بحدّ ذاته نوع من انتصار، في مقدّمته الانتصار على الذات. إنها الثقافة والسمو والعمل على الذات ما يدفع عن هذه الذات خطر التفكك والعنف والعدوانية المدمّرة.
لقد وصل بنا الحدّ بعد هذه التجربة السريالية لعدم الوثوق بسياسات صحية ناجعة. لا بل بلغنا مبلغاً من التشكيك بالعلم والاختبارات عندما وضع العلم بتصرف أصحاب إيديولوجيا فرضوا بالمال والرشوة والضغط وتزوير الحقائق المنطق الذي أرادوه. عندما طرح اللقاح بسرعة فائقة في السوق، وهو ما زال في مرحلة تجريبية، ليجرّب على البشر وبكامل إرادة من قبل به وصدق فائدته على صحته. وللأسف، ما زال الوضع مستمراً بهذا العمى في بعض البلدان، وكأنّ حجم الاعترافات بالدراسات المزوّرة والضغوط الممارسة والتداعيات الصحية على الملقحين لم تكن كافية لإيقاف الجنون الزاحف والمهدّد للبشرية.
برنامج «ما خفي أعظم» لتامر المسحال، مراسل قناة «الجزيرة» من غزة، يستحقّ المشاهدة، لما تضمّنه من معطيات هامة وبحث رصين تناول اللقاحات، ومنها ما استعمل ضدّ انفلونزا الخنازير وايبولا. لقد بيّن بالوقائع الفساد الذي فاحت رائحته والضغوط التي استعملت على الخبراء وتزوير التقارير وحجبها عن طالبيها، كما تطرق للدعاوى التي أقامها المتضرّرون من هذه اللقاحات والعقارات، والتي من بينها شركة بفايزر السيئة الصيت التي سدّدت مليارات الدولارات كتعويضات لضحاياها.
هذه الإجراءات القمعية كان لها أن تفضي إلى كارثة اقتصادية، وهذا هو المطلوب. لكن الأخطار التي يتمّ التحضير لها من نفس الأطراف وغيرها لن تتوقف عند هذا الحدّ، كونها أيضاً بيولوجية وسيبرانية وبيئية ومناخية إلخ…
في سنة 1950، أعلن سالومون آش عن أعماله حول الالتزام الجمعي، أو كيف أنّ الفرد يتبع رأي المجموعة حتى لو شعر بأنّ الموضوعية بعيدة كلّ البعد عن موقفه. وقد تأثر بتجاربه تلميذه ستانلي ميلغرام الذي كتب أطروحته عن الأوامر القاتلة والامتثال للأغلبية حتى ولو مخطئة. لقد ذاع صيت هذه الأعمال لما قدّمته من براهين عن الانقياد الأعمى لحكم المجموعة، كما ألهمت كثيرين لاستثمار آلياتها.
يبقى أنّ الحقبة التي نعيشها تشهد نوعاً من التحوّلات الكبرى في العالم، في وقت لا تعلم أغلبية البشر ما هي القواعد التي تتحكم بحياتها. لكن إدراك كنهها ضروري لاجتياز التجارب الصعبة المعاشة. خاصة عندما تترك خبرات الطفولة جراحاً غائرة في النفس المعذبة. هذه الجراح التي يتمّ تجاهلها بإعمال آليات دفاعية منها الإنكار والإسقاط. فتبقى جوانب غامضة غير مسيطر عليها بمثابة انعكاس لمخزونات لاوعيه تستفيق مع كلّ هزة ريح. لكن الانتقال من مستوى الغرائزي ـ الحيواني لما هو أعلى مرتبة وارتقاء للمستوى الروحاني، يحتاج للكثير من العمل على الذات. بانتظار ذلك، تبقى الحياة صراعاً على مستلزمات البقاء، وتكثر فيها الأمراض النفسية والجسدية. كما يغيب عن الذهن أنّ السعادة هي في ما يتقاسمه البشر بين بعضهم وليس على حساب بعضهم.










