أكاديميون في مجلس الوزراء : تعزيز أم تراجع لدور الأكاديمي في المشروع الوطني الفلسطيني؟ (*) - CAUS - مركز دراسات الوحدة العربية
ملخص:
تناقش هذه الورقة دور الأكاديمي الفلسطيني في المشروع الوطني المتمثل بالتحرر من الاحتلال وتقرير المصير في مرحلة ما بعد تأسيس السلطة الفلسطينية التي قامت على أساس اتفاق أوسلو 1993. تركز الورقة بشكل خاص على علاقة الأكاديمي بالسلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الجهة الرسمية الحاملة للمشروع الوطني، وتجادل بأن هذا الدور قد تراجع بالمقارنة مع الدور التاريخي الريادي الذي لعبه الأكاديمي الفلسطيني في ظل الاحتلال المباشر في مرحلة ما قبل اتفاق أوسلو. ولذا تسأل الورقة إن كان الأكاديمي الفلسطيني قد تخلى عن دوره القيادي والمقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي وأصبح جزءًا من السلطة يتماهى معها ويدافع عنها ويطمح إلى الترقية في هياكلها، وهل عمل الالتحاق بالجهاز البيروقراطي للسلطة على ترويض الأكاديمي الفلسطيني على غرار انخراطه في برامج المنظمات غير الحكومية الدولية ذات التخصص المهني والفني الدقيق غير المرتبط بالضرورة بالمشروع الوطني المقاوم، أم أثبت الأكاديمي «قدرته على التغيير من الداخل» كما يفسر الكثير من الأكاديميين سبب التحاقهم بأجهزة السلطة الفلسطينية؟
كلمات مفتاحية: المشروع الوطني الفلسطيني، السلطة الفلسطينية، الأكاديميين، المقاومة الأكاديمية، الأكاديمي الناشط، تقرير المصير الفلسطيني، الاحتلال الاسرائيلي.
Summary
This paper discusses the role of the Palestinian Academics in the national project of self-determination and liberation from the Israeli occupation after 1993, the establishment of the Palestinian Authority based on Oslo Agreement. Particularly, the paper examines the relationship between Academics and the Palestinian Authority as the official entity representing the national project. It argues that this role has declined in comparison with the historical leadership role that Palestinian Academics played in the pre 1993 Oslo phase. The paper asks whether Palestinian Academics are abandoned their leadership and resistance role against the Israeli occupation, becoming part of the Palestinian Authority, identifying with and defending its performance and aspiring to be promoted in its structures. Furthermore, the paper discusses whether joining the bureaucratic apparatus of the authority worked to ‘tame’ Palestinian Academics in a similar way to that with their close involvement in international NGOs that focus on technical specializations, not necessarily in advancing the national project. Finally, the paper asks whether the Academics proved their ability to «change from within» as many of them justify why they joined the Palestinian Authority.
Keywords: Palestinian National Project, Palestinian Authority, Academics, resistance, scholar activism, Israeli occupation, Palestinian self-determination.
يُنظر إلى الأكاديميين على أنهم يمثلون شريحة رئيسية من المثقفين في أي مجتمع وذلك لأسباب تتعلق بمستوى تعليمهم الرفيع ولوجودهم في مراكز قيادية في العملية التعليمية والتربوية في مجتمعاتهم. من جهة أخرى، فعلاقة الأكاديمي المثقف بالسلطة حساسة، كما هي جدلية، حيث ينظر البعض فيها إلى المثقف على أنه يمثل ضمير المجتمع وصاحب الدور الرقابي والأخلاقي على السلطة وصوت من لا صوت لهم، في حين يرى آخرون أن بقاء الأكاديمي المثقف في بروج عاجية يؤدي إلى عزلته عن محيطه الاجتماعي والسياسي، بينما انغماسه في السلطة يمكّنه من إحداث التغيير المطلوب من الداخل، وهو ما يحتاج إليه المجتمع، وخصوصًا عندما تكون السلطة فاسدة وظالمة وقامعة للشعب. ولكن، وفي الوقت نفسه، فإن دخول المثقف إلى السلطة قد يؤدي به إلى التحول ليصبح جزءًا من هذا الواقع، ليس بالضرورة أنه يشارك السلطة فسادها ولكن فقط لعجزه عن إحداث تغيير في هذا المحيط لأنه وببساطة أقوى منه، كما أنه، وهذا الأخطر، يمكن للأكاديمي المثقف غير الفاسد أن يضفي نوعًا من الشرعية على هذا الواقع كونه أصبح جزءًا منه. وبما أن الأكاديمي المثقف يأخذ موقف الرقيب الأخلاقي والقيمي – أو هكذا يفترض – فلا بد له من أن يتبوأ مواقع متقدمة في الثورة وعملية التحرر كما كان عليه الحال في فلسطين عندما أخذ المثقف الأكاديمي دوره ضد الاحتلال الإسرائيلي وتعسُّفه فتعرّض للاعتقال والإقامة الجبرية والإبعاد.
تناقش هذه الدراسة دور الأكاديمي المثقف في المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بالتحرر من الاحتلال وتقرير المصير، في مرحلة ما بعد تأسيس السلطة الفلسطينية التي قامت على أساس اتفاق أوسلو 1993. تركز الدراسة بوجه خاص على علاقة الأكاديمي المثقف بالسلطة الوطنية الفلسطينية بوصفها الجهة الرسمية الحاملة للمشروع الوطني، وتجادل بأن هذا الدور قد تراجع بالمقارنة مع الدور التاريخي الريادي الذي أدّاه الأكاديمي الفلسطيني في ظل الاحتلال المباشر في مرحلة ما قبل اتفاق أوسلو. فهل تخلى الأكاديمي المثقف عن دوره القيادي والمقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي وأصبح جزءًا من السلطة يتماهى معها ويدافع عنها ويطمح إلى الترقية في هياكلها؟ وهل عمل الالتحاق بالجهاز البيروقراطي للسلطة على ترويض الأكاديمي المثقف، على غرار انخراطه في برامج المنظمات غير الحكومية الدولية ذات التخصص المهني والفني الدقيق غير المرتبط بالضرورة بالمشروع الوطني المقاوم؟ أم أثبت الأكاديمي «قدرته على التغيير من الداخل» كما يفسر الكثير من الأكاديميين سبب التحاقهم بأجهزة السلطة الفلسطينية؟
منهجيًّا، اطلعت هذه الدراسة على الأدبيات الخاصة بالموضوع من المصادر الثانوية. كما أجرى الباحث مجموعة من المقابلات مع أكاديميين فلسطينيين مهتمين بالشأن العام وبنهوض المشروع الوطني. إضافة إلى ذلك، تتبع الباحث تمثيل الأكاديميين الفلسطينيين في الحكومات الثماني عشرة للسلطة الوطنية ابتداءً من الحكومة الأولى التي تألفت بعد اتفاق أوسلو 1993، وانتهاءً بما أُطلق عليه «حكومة الفصائل» عام 2019، لدراسة مدى حضور الأكاديميين في السلطة ومؤسساتها الرسمية، وإذا ما كان من شأن ذلك احتواء دورهم السياسي داخل المجتمع الفلسطيني. وللوصول إلى تعريف إجرائي محدد للأكاديمي الفلسطيني فقد عدّته الدراسة أنه الشخص الحاصل على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المعترف بها محليًّا أو دوليًا وقد انتظم بالتدريس في إحدى مؤسسات التعليم العالي لفترة زمنية لا تقل عن عام واحد.
أولًا: أهمية الأكاديميا للعمل الوطني
تنبع أهمية دراسة دور الأكاديميين في الشأن العام – النهوض بالمشروع الوطني في الحالة الفلسطينية – وفي عملية التغيير الاجتماعي من مجموعة من العوامل الذاتية، المتعلقة بالدرجة الأولى بكونهم منتجين للمعرفة التي هي نوع من أنواع القوة الفاعلة في العصر الحديث، وما يترتب عن ذلك من امتيازات يمتلكونها وتجعلهم قادرين على أداء دور متميز يسهم في تحقيق التغيير المطلوب. يعزز قدرتهم على صوغ الرؤى للتحديات المجتمعية كونهم عاملين خارج إطار السلطة غير واقعين تحت تأثير ديناميات الحكم، والحاجة إلى الوصول إلى صيغ تحافظ على مصالحهم الخاصة، وعلى رأسها البقاء في الحكم. إذًا هي نسبيًّا ونظريًا رؤىً خالية من التضارب في المصالح (Conflict of Interest).
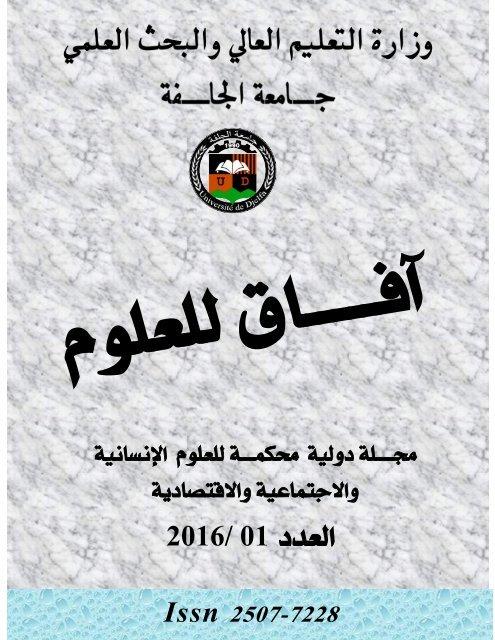
يملك الأكاديميون نوعًا مهمًّا من أنواع القوة داخل المجتمع تتمثل بقدرتهم على التأثير في الرأي العام المجتمعي وما يصاحب ذلك من نفوذ في الضغط على السلطة السياسية في الدولة. تنبع قوة الأكاديميين في هذا المجال من عاملين: يتمثل الأول بالمكانة الاجتماعية التي يتمتعون بها، والتي توفر لهم مستوىً معينًا من الحماية من بطش السلطات فتجعلهم أقدر على المجاهرة في تحدي السلطة ونقدها؛ والثاني بحكم إنتاجهم المعرفي الموجه للرأي العام معظم الأحيان. هذه القدرة على التأثير العمومي تساعد على خلق نوع من التوازن في علاقات القوة ما بين السلطة السياسية وقوى المجتمع المدني فيجعل التغيير أكثر احتمالًا.
تمنح المكانة الأكاديمية قدرات خاصة لأصحابها حيث تؤهلهم لمخاطبة المجتمع الدولي وللدفاع عن قضايا مجتمعاتها، بمستوى مختلف من حيث الأداء والفضاء المخاطب عمّا تقدمه السلطة السياسية. هو ليس بديلًا لما تقدمه السلطة السياسية، ولكن مكملًا في جوانب كثيرة لما لا تستطيع الأخيرة الوصول إليه. فلسطينيًا، أحدثت شخصيات أكاديمية اختراقات في الساحة الدولية في دفاعها عن عدالة القضية الفلسطينية، حيث لم يكن بإمكان منظمة التحرير الفلسطينية، أو السلطة الفلسطينية، القيام بها نتيجة لاختلاف تخصص كل منها. لقد أحدث أكاديميون فلسطينيون، مثل إدوارد سعيد وإبراهيم أبو لغد وهشام شرابي ووليد ورشيد الخالدي وغيرهم كثيرون، تأثيرات ذات شأن حول عدالة القضية الفلسطينية في فضاءات دولية كثيرة، إذ لم يكن لقيادات فلسطينية رسمية أخرى الوصول إليها ليجادلها ويحدث التأثير المنشود لديها[1].
من جهة أخرى، فإن هناك قسمًا من الأكاديميين عادة يرفضون الانضواء في الأحزاب، وذلك لأسباب متأصلة (Inherent) في طبيعة كلا العملين الحزبي والأكاديمي. ففي حين يتوقع الحزب السياسي من أفراده الإيمان بمواقفه وتبنّيها والدفاع عنها حتى إن لم يكن الفرد مقتنعًا بها، يُتوقع من الأكاديمي العامل بإنتاج المعرفة الالتزام بالموضوعية والبحث عن الحقيقة والانحياز لها وحدها فقط، بغض النظر عن الحزبية. يؤدي المنهج الأكاديمي الموضوعي وظيفة مجتمعية مهمة، وبخاصة في أوقات الاستقطاب السياسي الحاد كونه يعمل خارجه، ويمكن لما يوصِل إليه من نتائج أن يكون أرضية لقاء لمن هم خارج هذا الاستقطاب أيضًا. وفي حالة وجود عمل أكاديمي جماعي منظم فإن من شأن ذلك أن يجعل من الأكاديميين طرفًا ثالثًا ضاغطًا يعمل ضد الاستقطاب.
وهناك أهمية أخرى لدور الأكاديميين في الشأن العام تتمثل بقدرة الأكاديميا الوطنية على الإسهام في تحسين عملية صنع القرار الوطني من خلال إغنائه بالمعلومة والبحث العلمي. وفي هذا الصدد يرى علي الجرباوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، بأن سببًا رئيسيًا في انخفاض مستوى الأداء السياسي في الوطن العربي بوجه عام هو الفجوة الكبيرة ما بين المعرفة والقرار السياسي[2]. فعملية صنع القرار السياسي لا تحوي إنتاجًا معرفيًّا كجزء أصيل من العملية نفسها. وعليه، يمكن للأكاديميين العاملين في إنتاج المعرفة المساهمة في سد هذه الفجوة من خلال خلق الآليات المناسبة لذلك، سواء كان بتأسيس مراكز الفكر (Think Tanks)، أو بالنصيحة المباشرة لصناع القرار السياسي، أو بإصدار موجز السياسات (Policy Briefs) أو حتى الندوات العامة وغير ذلك. وفي هذا تحديدًا ينبه الجرباوي إلى أنه يصعب على الأكاديمي التأثير بمفرده في عملية صنع القرار من خارج السلطة، إذ لا بد له من العمل من خلال مؤسسات، أو أحزاب سياسية، أو مجموعات ضغط، توفر له الإطار المناسب للتأثير، ويستدل بذلك على النموذج الغربي مثلًا؛ الذي وفّر مراكز فكر مثل مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ومجلس العلاقات الخارجية وغيرهم الكثير، التي تحولت إلى رافد إضافي للتأثير المعرفي في القرار السياسي. وبالرغم من ذلك يقر الجرباوي بأن بعض الأكاديميين قد حققوا بصورة فردية مكانة دولية أهّلتهم ليكون لهم نفوذ (Leverage) وتأثير في العمل السياسي في مناطق تخصصهم.
أخيرًا، يبقى تأثير الدور الأكاديمي في الشأن العام حيويًّا، ليس فقط آنيًّا، ولكن على المدى الاستراتيجي أيضًا. فالأكاديميون هم من يشرفون على العملية التعليمية لعنصر الشباب الذي يؤدي عادة دورًا محوريًا في الثورات وحركات التغيير الاجتماعي. فالطلبة الجامعيون على تواصل مباشر مع أساتذتهم، ويقعون تحت تأثير ممنهج من جانبهم ولعدة سنوات، وهذا يعطي الأكاديميين دورًا مهمًّا في التأثير بالقيادة المستقبلية للمجتمع.
ثانيًا: دور الأكاديمي المثقف في الشأن العام
ليس كل أكاديمي مثقفًا ولا كل مثقف أكاديميًّا، بيد أنه يُتوقع مجتمعيًا أن يضطلع الأكاديمي بمهام المثقف، وعلى رأسها تبنّي قضايا مجتمعه والانحياز للجانب الأخلاقي في علاقة الدولة بالمجتمع، مجتمعه. كذلك هناك الأكاديمي الناشط الذي يضيف بعدًا جديدًا لهذه العلاقة؛ فهو يتماهى مع الأكاديمي والمثقف في جوانب ويتميز بجوانب أخرى. يوضح الشكل الرقم (1) العلاقة ما بين هذه التعريفات، وكذلك الحيز الذي تتقاطع به، والذي يعتبر نطاق اهتمام هذه الدراسة.
الشكل الرقم ( 1)
العلاقة ما بين الأكاديمي والمثقف والناشط
ولنبدأ أولًا بالمثقف، إذ يعتبر انطونيو غرامشي أن كل من يعمل في مجال يتصل بإنتاج المعرفة ونشرها مثقف (سعيد، 2006: 40). فالمثقف صاحب رسالة وله دور حيوي في الشأن العام المجتمعي. اختلف المنظرون على صورة هذا الدور، والطريقة التي يتم فيها التعبير عنه، حيث يدور الحديث عن أنواع مختلفة من المثقفين. فقد اعتبر جوليان بندا (Benda, 1969: 34) المثقفين «ضمير البشرية» في دراسته التي كتبها بعنوان «خيانة المثقفين» حيث يرفض هؤلاء المثقفين الذين يعيشون في بروج عاجية (كما يفعل قسم من الأكاديميين) والذين ينغمسون في الجدل حول قضايا غامضة فينعزلون عن الآخرين ويعيشون في عوالمهم الخاصة. فالمفكرون الحقيقيون أقرب إلى الصدق مع أنفسهم، وتدفعهم المبادئ السامية كالعدل والحق وفضح الفساد والتصدي له، والدفاع عن المستضعفين، كما أنهم يتحدون السلطة المعيبة أو الغاشمة (Said, 1996). وفي السياق نفسه أشار غرامشي في دفاتر السجن إلى «المثقف العضوي» (Gramsci, 1971: 3‑23) الذي عرّفه بأنه «ذلك المثقف (الحزبي أو غير الحزبي) القادر على إماطة اللثام عن الواقع الاجتماعي غير الطبيعي، وأنه يمكن تغيير ذلك الواقع بالقدرة على تحليل ثقافته ونقدها، وتحقيق الهيمنة الثقافية للمضطهدين» (بشارة، 2013: 5). يميّز غرامشي بين المثقف التقليدي المُترفِّع عن الواقع وعن عموم الناس من جهة، وبين المثقف العضوي الذي يُكابِد مع شعبه ويحمل هموم شعبه ويتبناها، فيصبح ذا شأن في عملية التغيير الاجتماعي.
تأثر إدوارد سعيد بوجه خاص برؤية بندا وغرامشي لدور المثقف في المجتمع وعلاقته مع السلطة، حيث يرى أن «المثقف ينهض بدور محدد في الحياة العامة في مجتمعه، ولا يمكن اختزال صورته بحيث تصبح صورة مهني مجهول الهوية، أي مجرد كفؤ ينتمي إلى طبقة ما يمارس عمله وحسب» (سعيد، 2006: 43 – 44). فالمثقف، حسب إدوارد سعيد، يحمل رسالة ويمثل موقفًا، أو فلسفة محددة، يفصح عنها ويدافع عنها ممثلًا لأشخاص وقضايا يكون مصيرها النسيان أو التجاهل والإخفاء، فهو فرد يصعب على الحكومات أو الشركات استقطابه حيث «يقوم بهذا العمل على أساس المبادئ العامة العالمية، وهي أن جميع أفراد البشر من حقهم أن يتوقعوا معايير ومستويات سلوك لائقة مناسبة من حيث تحقيق الحرية والعدالة… وأن أي انتهاك لهذه المستويات والمعايير السلوكية، عن عمد أو دون قصد، لا يمكن السكوت عليه، بل لا بد من إشهاره ومحاربته بشجاعة» (سعيد، 2006: 43 – 44).
آمن إدوارد سعيد بضرورة ابتعاد المثقف عن السلطة، وعدم الخدمة في أجهزتها أو العمل كمستشار لديها، حيث يرى أن المثقف ينتمي أصـلًا إلى مبادئ عالمية ويمثل المستضعفين ويدافع عنهم. ويروي سعيد عن نفسه أنه لم يكن يهتم بالاستشارات مقابل الأجور التي تقدّم من الحكومات «حيث تجهل في هذه الحالة أسلوب استخدام أفكارك أو الانتفاع بها في المستقبل». ويضيف بأنه كان يرحب على الدوام بالمحاضرات الجامعية ويرفض ما عداها، حيث لم يتوقف «عن قبول الحديث في المناسبات التي تتيح زيادة الجرعة السياسية في حديثي، وكنت ألبي – بانتظام ودون تردد – كل دعوة أتلقاها من الجماعات الفلسطينية، أو من الجامعات في جنوب أفريقيا لزيارتها والحديث المناهض للفصل العنصري والمناصر للحرية الأكاديمية» (سعيد، 2006: 150).
علاقة المثقف بالسلطة إذًا أخذت حيزًا كبيرًا من نقاش المثقفين بمن فيهم العرب الذين طرحوا ما أصبح يعرف بـ «تجسير العلاقة ما بين المثقف والسلطة»، وهي عبارة عن محاولة للمثقفين من ردم الهوة بين المثقف والسلطة وخلق نموذج للعمل المشترك تحت ترتيبات مختلفة. هدف المثقفون من هذا التجسير إلى محاولة ما أسموه «التغيير من الداخل» الذي يسمح لهم بالتأثير في السلطة ليس من الخارج أو على شكل «محاضرات إدوارد سعيد» ولكن من خلال النصح والتنوير، وأحيانًا القيام بمهام محددة للسلطة مع ترك بصماتهم كمثقفين عليها، والتي برأيهم إن لم يفعلها المثقفون سيفعلها أشخاص آخرون، فلسان حالهم يقول فلنفعلها نحن بالطريقة التي تخدم القضايا النبيلة والمبدئية التي نتبناها بفكرنا وندافع عنها كمثقفين. يُطلق عزمي بشارة على هؤلاء ما يسميه «المثقف الإصلاحي» حيث يجادل بأنه يستطيع التغيير ضمن ظروف محددة تتعلق بطبيعة النظام إلا أنه يشكك بقدرة هذا النوع من المثقفين على تحقيق التغيير في نهاية المطاف. يقول، المثقف الإصلاحي هو «الذي يحاول أن يؤثر في اتجاه تقديم التغيير عبر تسويات مدروسة، ويساوم في سبيل تغيير النظام من داخله، وليس عبر كسره بالثورة فيما يشاع عربيًا تحت صيغة «تجسير العلاقة بين المثقف والسلطة». وينجح هذا المثقف الإصلاحي في حالة أنظمة تستنتج ضرورة الإصلاح، والتكيف مع حركة التاريخ من أجل البقاء من دون تحجر. ولكن المثقف الإصلاحي يصل إلى طريق مسدود في نظام الاستبداد المطلق» (بشارة، 2013: 16).
يجد الأكاديمي المثقف نفسه أحيانًا وقد أصبح جزء من ظاهرة ما يسمى «التكنوقراط»، والتي تُعرّف عمومًا على أنها الإدارة العلمية أو الفنية لشؤون الدولة والقائمة على التخصص وليس الانتماء السياسي أو الفكري للعاملين فيها. تؤبف حكومات التكنوقراط عادة كحل لأزمات سياسية تعصف بالحكم وحين تعجز الأحزاب السياسية عن التوافق فيما بينها على إدارة شؤون الدولة، فيتم استدعاء أكاديميين متخصصين وخبراء فنيين من مؤسسات دولية قانونية واقتصادية مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها ليحلوا محل الحكومات السياسية في إدارة شؤون الدولة، وذلك حتى إجراء انتخابات جديدة أو الوصول إلى تسويات سياسية أخرى. وقد شهدت بلدان الربيع العربي تحديدًا ازدهارًا غير مسبوق لتبني حلول التكنوقراط لتجاوز أزماتها السياسية المتعاقبة.
في الوقت نفسه هناك «الأكاديمي الخبير» الذي يكرّس وقته وجهده واهتماماته للإنتاج المعرفي الفني المتخصص منعزلًا عن قضايا الشأن العام أو الوضع السياسي القائم. يتناقض «الأكاديمي الخبير» مع «الأكاديمي الناشط» وهو الذي لا يهتم فقط بالشأن العام وتبنّي قضاياه والدفاع عنها فكريًا في ما يعرف أحيانًا بالمثقف العام (Public Intellectual)، بل يتعدى لغة التفكير والنقد والتنظير إلى الفعل الاجتماعي أي إلى الانخراط في الواقع، يتبنى أهدافًا وقضايا محددة ويحشد لها على مستويات مختلفة لإحداث التغيير المنشود. يقود الأكاديمي الناشط الفعل الاجتماعي لإحداث التغيير المطلوب، ولا يكتفي بالكتابة عنه أو الحديث عنه في محاضرات تنظمها صروح أكاديمية متعددة. هو ينتقل من التفكير إلى العمل. فالأكاديمي الناشط، حسب جون ديوي، هو من «يقوم بتشكيل الواقع الذي يقود إلى أهداف اجتماعية إيجابية، لا أن يقف جانبًا في بيئة ذاتية فاضلة منعزلة عن الواقع» (Dewey, 1969‑1991). وقد عُرف عن الأكاديمي الناشط تاريخيًا بأنه صاحب مسؤولية ربط التفكير والمعرفة مع الفعل العملي على الأرض (Tilley and Taylor, 2014: 55). وفي هذا السياق، كتب غرامشي في دفاتر السجن «طريقة المثقف الجديد لم تعد مقتصرةً على الفصاحة اللغوية ولكن بال الفاعلة في الحياة العملية كمنظم (Organizer) وبانٍ (Constructer) ومقنع (Permanent Persuader)» (Gramsci, 1971: 68). ما نطلق عليه هنا «الأكاديمي الناشط» يسميه غرامشي «المثقف الجديد»، ويحدد له أدوارًا مرتبطة بالفعل الاجتماعي كمنظم وبانٍ تتعدى ما عُرف عن المثقف العام، أو العضوي، الذي يكتفي بالجانب النقدي للسلطة والتنويري داخل مجتمعه.
تشرح جانيت كونوي دور الأكاديمي الناشط في المجتمع حين تقارنه بـ «الأكاديمي السياسي» (Political Scholar)، وهي تسمية أخرى للمثقف العام أو العضوي عند البعض، فتقول «الأكاديمي السياسي يكون ملتزمًا بقيم وأفكار سياسية تقدمية (Conway, 2004)، وكذلك يمكن أن يكون يمينيًا أو شعبويًّا أو محافظًا وغيره. ورغم أن الأكاديمي الناشط هو الآخر ملتزم سياسيًا، إلا أنه يختلف عن الأكاديمي السياسي بأنهم يعملون كناشطين مع ناشطين آخرين في فضاءات غير أكاديمية؛ وعليه لا يُعرفون فقط كأكاديميين وإنما كجزء من المجتمع الأوسع للمفكرين والناشطين يشاركونهم الرؤية الجماعية والهدف وفكرة التغيير أيضًا. أن تكون أكاديميًّا ناشطًا – تقترح كونوي – يعني أن تشارك في العمل اليومي وفي اجتماعات لا نهاية لها، ويعني أيضًا أن تقدر المساهمات الأخرى المقدمة للقضية (التي تؤمن بها)» (Tilley and Taylor, 2014: 55).










